لا تستحق قطاعات الانتاج والخدمات في لبنان صفة الخاوية على عروشها، ما دام أن هناك قطاعاً خاصاً، لديه من الاقتدار المالي والإداري والتقاني، ما يمكنه من نقل المراكب الى شاطئ الأمان، ولعلّ المصارف اللبنانية، هي الأقدر على تفسير أحلام مشاريع اللبنانيين، من ماء وكهرباء وطاقة وبنى تحتية، من خلال المحفظة المالية المملوءة بأكثر من مئة مليار دولار.
وفي المقابل، فإن القطاع العام ولا سيما في شقه الخدماتي، يكاد ينهار تحت وطأة الأعباء المالية الناتجة عن الفشل الإداري وانعدام الخبرة نحو التطوير والتحديث، وسياسات الترقيع التي لا تسمن ولا تغني. وربما تكون الكهرباء نموذجاً للفشل الرسمي في المعالجة.
تظهر بصمات القطاع الخاص لامعة وبراقة في الأمكنة التي يتواجد فيها، الخدمة التي يقدمها يشهد لها الجميع بالجودة والتميز، فيما يغط القطاع العام في سبات عميق، وليس بعيداً من لبنان، فإن سوريا ستمنح أول امتياز لمحطة كهرباء خاصة في البلاد بحلول نهاية كانون الثاني (يناير) 2011. وهي تسعى لجمع استثمارات خاصة تصل لنحو 45 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، لتحديث البنية التحتية المتهالكة، بعد أربعة عقود من السياسات الاقتصادية الفاشلة على النمط السوفياتي. فالحكومة السورية التي تلتزم الاقتصاد الملتزم، تشبه اليوم سائق السيارة الذي يعطي إشارة الى اليسار فيما يتجه فعلياً الى اليمين، فاشتراكية الاقتصاد السوري هي باتجاه تحرير القطاع العام، مستخدمة مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لوصف السياسة الجديدة لخصخصة الكهرباء.
ومن هنا، فإن القطاع الخاص في لبنان يمكنه تحريك استثمارات بما لا يقل عن 10 مليارات دولار. وبمعنى آخر فإن تحريك عجلة الاقتصاد، يتطلب إقراراً سريعاً لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لقد شكلت الضغوط السياسية على الحكومات المتعاقبة، بعيد اغتيال الرئيس الشهيد، سنوات من التيه الاقتصادي، وبالرغم من ذلك، فإن لبنان لم يتراجع نموه، بيد أن الأولويات تداخلت وتشابكت، وبالرغم من اتفاق الدوحة بين الأطراف المتنازعة في أيار (مايو) 2008، فإن البعض من السياسيين يدلف التهديدات دلفاً، دونما الأخذ بالاعتبار تأثير ذلك في الاقتصاد الوطني برمته، فلا موازنة 2010 أقرت والخوف على موازنة 2011 من أن تلقى المصير نفسه.
4 سنوات ولبنان يخوض جدلاً حول الخصخصة والشراكة والامتيازات، 4 سنوات تضيع في غيابة الجدل، وتزيد من ترهل القطاعات، ففي حزيران (يونيو) 2007 كان هناك مشروع قانون حول الشراكة بيد أنه لم يحول الى مجلس النواب، ثم تلاه اقتراح قانون تقدم به النائب عن كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل باقتراح قانون حول الشراكة في نيسان (مايو) 2010، وعلى الرغم من مناقشته في مجلس النواب إلا أنه لم يبصر النور.
قانون جديد
بعد التعثر الحاصل في إقرار قانون الشراكة طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مشروع قانون لتقترحه الحكومة، وقد شكلت لجنة وزارية لهذه الغاية برئاسته، للخروج بقانون يرضي الجميع.
ويقول الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، إنه لا توجد فروق كبيرة بين ما يحضر الآن والمشاريع التي قدمت من قبل، بيد أن المشروع الأخير يشارك في صياغته عدد كبير من الخبراء، ويأخذ بالتطورات الحاصلة في هذا المضمار، خصوصاً وأن الشراكة تتعدد وتتنوع. ويضيف أن القانون الجديد الذي يجري العمل عليه فيه تطوير للنصوص ويأخذ في الاعتبار كل نواحي التطوير التي ظهرت خلال الفترة المنصرمة، ليكون القانون أكثر أمناً، بحيث تتوضح فيه بعض الأفكار ليسهل فهمها، فقد أخذ برأي ملاحظات اللجنة القانونية في جمعية المصارف، كما أنه سيتضمن الكثير من أفكار صندوق النقد والبنك الدوليين، خصوصاً وأن هناك لجنة من كبار الخبراء تشارك في الصياغة الجديدة للمشروع.
ولفت الى أنه في السابق كان هناك نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بيد أنها كانت تتم دون تنسيق أو خبرة في دراسة المشاريع أو في المفاوضات على العقد.
وقال إن القانون هدفه خلق وحدة مركزية للقيام بموضوع الشراكة وهي ما يعرف بالppp، ليكون للدولة فريق عمل متخصص يقوم بمهمات الشراكة. ويشير الى أن بعض الناس تفكر بأن الشراكة ذات بعد سياسي، أو أنها طاولة تجمع بين الطرفين، وهذا ليس من الشراكة بشيء، لذلك فإن تعريف الشراكة بين القطاعين مهم. فهناك من جهة عقد الإدارة، تعطيه الدولة للقطاع الخاص للقيام بتأمين خدمة للدولة أو المواطن، وهذا لا يكون شراكة، لأن مخاطر المشروع يبقى على عاتق الدولة ولا تتحمله الشركة، إذ أنها تأخذ أتعابها ولا تتحمل إلا الخسائر الطبيعية.
أما الخصخصة فهي أن تحول الدولة المشروع بأكمله الى القطاع الخاص، وتكون مهمتها فقط التنظيم والمراقبة، والمخاطر تكون على عاتق القطاع الخاص، إذاً ما بين عقد الشراكة والخصخصة هناك مسحة مشاركة في المخاطر بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما يمكن تسميته بالشراكة، إذ يتحمل القطاع الخاص بعض المخاطر (التشييد والانشاء) أو مخاطر (التنفيذ والتشغيل) والدولة تتحمل في المقابل مخاطر التعرفة للمواطن أو تلك المخاطر الناتجة عن الحروب، وما يميز عقد الشراكة أن الدولة تشتري الخدمة، ففي الأصل كانت الدولة تقوم بمناقصة لمشروع معين تحدد فيه كل نواحيه وعناصره، إلا التكلفة والسعر.
أما في الشراكة فتكون المفاصلة على أساس السعر الأحسن بغض النظر عن تفاصل المشروع، فإذا أخذنا مثلاً أننا نحتاج الى معمل كهرباء فالدولة يهمها تأمين الكهرباء بأقل سعر ولا تتدخل في مواصفات المشروع، وبمعنى آخر فإن الشراكة تتجه نحو المرونة لانتاج سلعة ما، وهي تعني المشاركة في المخاطر وفي تحديد المخرجات وهما الأساس في الشراكة.
المواصفات المطلوبة
ولكن هل أي شركة يمكنها الدخول في الشراكة مع الدولة؟، يقول حايك لا يكتمل معنى الشراكة إلا من خلال أشياء عدة:
-الخبرة اللازمة للشركة، ولتمييز العرض يجب أن يكون هناك فريق عمل يتبع المجلس الأعلى للخصخصة لتحديد الخبرات ودراسة العرض المقدم، والتأكد من تقديم الخدمة ومن القدرة على تحمل المخاطر.
-فريق عمل متخصص، فلا يكفي أن يأتي مهندس من وزارة لإعطاء تقرير، فالفريق المتخصص تكون مهمته التأكد من القدرة المالية والتمويلية للشركة المتقدمة، من مواصفاتها، وعلاقاتها بصناديق التمويل وهل هذه الأمور مضمونة، وهذا لا يمكن أن يقوم به إلا فريق عمل متخصص في جميع النواحي.
-المشاركة في المخاطر والمفاوضة على العمل، وهذا أيضاً يتطلب فريق عمل قادراً على المفاوضة في أدق التفاصيل، ليكون هناك توازن في المفاوضة ولا يكون هناك مغبون، خصوصاً وأن عقود الشراكة هي من العقود الطويلة وأي غبن سيتجلى سلباً في المشروع، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون هناك حماية للمصلحة العامة، فالمشاركة في المخاطر يجب أن تكون فعلية، فكل فريق يأخذ من خلال المفاوضة المخاطر التي يستطيع حلها، وهذه المخاطر قد تكون متنوعة قانونية وبيئية وتجارية وتقانية وغيرها.
وإنطلاقاً من هذا الأمر نعود الى أهمية تشكيل الوحدة المركزية الppp، والتي يجب أن تتبع حكماً مجلس الوزراء لا وزارة، لكنها تستطيع العمل وبشكل مستقل مع كل وزارة في اي مشروع وبمرونة.
ومن هنا فإن القانون الذي تبحثه اللجنة الوزارية يحدد ما هو الاطار التنظيمي للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ويحدد ما يجب أن تتضمنه العقود، ومن هنا فإن الوحدة المركزية للشراكة الppp، يفترض أن تكون المجلس الأعلى للخصخصة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الذي شكل لجنة دائمة من بعض الوزارات بالإضافة الى الوزير المعني بأي مشروع من خارج اللجنة.
يؤكد حايك أن المجلس الأعلى للخصخصة له دور كبير في هذا الأمر، من خلال الخبرة التي اكتسبها حول الشراكة، ولذلك يجب أن تكون الوحدة المركزية منوطة بالمجلس الأعلى للخصخصة لا أن تكون فريق عمل داخل أي وزارة، وبالتالي فإن بامكان فريق كبير يقوده المجلس الأعلى للخصخصة الحد من الفساد في تلزيم المشاريع. ويلفت الى أن الشراكة لا يمكنها أن تحل مشكلات البلد ككل، لأن الأمر يتطلب مجموعة كبيرة من الاصلاحات وكذلك قدرات تمويل عالية وامكانات كبيرة.
يرى حايك أن دولاً كبيرة وخلال مواجهتها لتداعيات أزمة المال العالمية، كانت البطالة التحدي الأكبر، ولذلك توجهت نحو الاستثمار في البنى التحتية التي تستطيع الالتفاف حول البطالة، بسبب قدرات التوظيف التي توفرها ولشرائح مجتمعية متنوعة. فالبطالة في لبنان وكما يقول حايك لا تجيد الدولة التعامل معها، والحل يعبر عنه المتعطلون من العمل بالهجرة، فالدولة بعد 15 سنة من الحرب يكاد يكون فيها الاستثمار معدوماً. ويرى أن الانفاق على هذا النوع من المشاريع هو من النوع الاستثماري لا الاستهلاكي، الذي بامكانه أن يشكل أرضية لجذب المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني وتطويره في مراحل لاحقة مستقبلياً. ومن هنا انطلقت فكرة الشراكة على أساس الانفاق الاستثماري على المشاريع، فيما على الدولة أن تتحمل الانفاق التشغيلي.
إذاً، الوقت مناسب لوضع برامج الإصلاح موضع التنفيذ الفعلي، استنادا إلى النجاحات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية التي سجلت معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8%. كما أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنسبة سنوية قدرها 33.2% إلى نحو 4.8 مليارات دولار عام 2009، ليستقطب بذلك نسبة 6% من الاستثمارات الواردة إلى المنطقة العربية مقابل نسبة بلغت 3.8% عام 2008.
وقد دفع الشتات السياسي القائم في البلد، منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بداية 2005، بالاقتصاد اللبناني الى سنوات من التيه، بفعل توالد الأحداث وتدرجها من أصغر الى أكبر، وفي أحيان كثيرة تشابك الاقتصادي مع السياسي وتحويله مادة سجالية.
مفهوم آخر
يرى الخبير الاقتصادي والاستشاري حسن عمر العلي، أنه في ظل إعادة تموضع قانون الشراكة أن القطاع العام في لبنان لا يملك ما يقدمه في موضوع التشركة مع القطاع الخاص، والأفضل أن يتم استبدال كلمة شراكة بـاشتراك القطاع الخاص مع القطاع العام. ويقول إن عقد الشراكة وبحسب القانون الفرنسي، هو عقد إداري تكلف بموجبه الدولة أو أي مؤسسة عامة تابعة لها طرفاً ثالثاً ولمدة معينة لأداء مهمة عامة، هدفها: بناء، تمويل، صيانة، استثمار، إدارة منشآت أو معدات أو أصول غير مادية ضروية لتوفير الخدمة العامة، إضافة الى التمويل الكلي أو الجزئي، باستثناء المساهمة في رأس المال. لذلك، من الضروري إزالة هذا الالتباس والغموض، من خلال مقاربة موضوع الشراكة والعقد الاداري، الذي يمكن أن يؤدي الى خلط ما بين التلزيمات والتخصيص والعقود، وهو ما قد يؤدي الى نسف الفكرة بمجملها. ورأى أن المشروع لن يبصر النور إذا لم تتوفر له بيئة حاضنة ومناسبة.



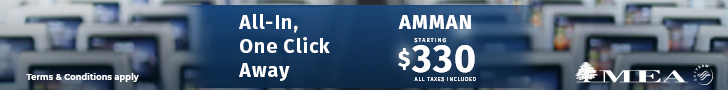

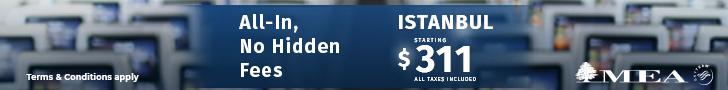
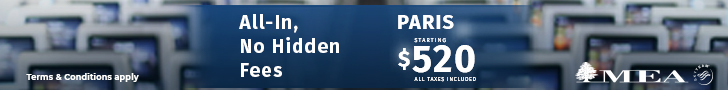



يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.