تلحظ استراتيجيّة التنمية الزراعيّة وبرنامج عمل الخمس سنوات المقبلة (20052009)، الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، المشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي في لبنان، والتي لا بد من تفكيكها وايجاد بدائل ناجحة تقيل هذا القطاع من عثراته، وعلى الرغم من عدم إقرارها بسبب المأزق السياسي الذي يمر به البلد، فإنها تبقى توثيقاً وخطة يمكن العمل والسير بها، بعد أن يعاد فتح السكك أمام القطار السياسي.
وتشير الاستراتيجية الى أن الأزمة التي يمرّ بها القطاع الزراعي، تعود بالخصوص إلى أسباب هيكلية تجعل من الضروري القيام بتقويم جذري للعديد من مكوناته وتوفير الإطار المؤسساتي الملائم، والتركيز على نوعية النمو وليس فقط على معدلاته، والاهتمام بقضايا التنمية التي تستهدف الإنسان وظروفه المعيشية، والقيام بإصلاحات تشمل دور الدولة وتنظيم المجال الزراعي التي من شأنها أن تكّون تصوراً جديداً نسبةً إلى القطاع الزراعي، على أن تحدد هذه الإصلاحات وأن تنجز في إطار جامع بين مختلف الفعاليّات والأطراف المعنية الرسميّة والخاصة.
وتهدف الاستراتيجية الموضوعة، الى: تأمين الاستخدام المستدام والرشيد للموارد الطبيعية، تحقيق الأمن الغذائي، تنمية المناطق الريفية والمعرضة للفقر، زيادة دخل المزارعين والعمل على توفير فرص العمل، تحسين القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية، والمساهمة في تحسين ميزان التبادل التجاري والميزان المالي.
وتشير الاستراتيجية الى أن تحقيق هذه الأهداف مرتبط بالتطورات الممكنة للوسائل الماديّة والتقنية والاقتصادية والسياسيّة، وبالتنظيم الناجع للموارد المتاحة على مستوى المكان والزمان.
وتعرض الخطة عدداً من النقاط، لبلورة السبل الآيلة للوصول إلى تنمية زراعية وريفية مستدامة:
1خصوصيات الواقع الزراعي اللبناني.
2استدراج الحلول الممكنة على ضوء الخيارات الوطنية الأساسية.
3وضع تصور حول آلية التنفيذ والبرامج اللازمة.
وتغطّي الأراضي الزراعية المستغلّة 25% من مساحة لبنان الإجمالية، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المستغلّة في لبنان نحو 248 ألف هكتار، منها نحو 104 آلاف هكتار مروية. وتغطّي الزراعات الدائمة نحو 47% من الأراضي الزراعية المستغلّة ويمثّل الزيتون الحيّز الوافر منها بنحو 52 ألف هكتار.
وتبقى الزراعة اللبنانية على الرغم من ضيق المساحة، حالة خاصة متميزة في منطقة الشرق الأوسط، اذ تتواجد ظروف مناخية وزراعية مختلفة جداً تفتح المجال لتنوع كبير في منتجاتها. ويُمكِّن توافر المياه حتى الآن، من ري نحو نصف الاراضي المزروعة ويقلص بشكل كبير من التأثير السلبي لتقلبات الطبيعة.
ويبلغ حجم اليد العاملة الموسمية في الزراعة 12.7 مليون يوم عمل في السنة، 52% منها للإناث. ويعتبر مستوى اللجوء إلى اليد العاملة الموسمية مرتفعاً بالنسبة للبلدان المجاورة (51 يوم عمل/هكتار/سنة) . واستناداً إلى نتائج الإحصاء الزراعي الشامل فإن 80% من الحيازات الزراعية تشغّل أقل من هكتار من الأراضي الزراعية، وتشمل أقل من 20% من المساحات الزراعية في لبنان. بالمقابل تبقى نسبة الحيازات المتوسطة أو الكبيرة التي يمكن ان تكون لها قدرة ذاتية على الاستثمار محدودة، إذ تمثّل 20% من عدد الحيازات على أقصى تقدير.
وتواجه الزراعة في لبنان العديد من العوائق المرتبطة أساساً بالوضعية غير المتماسكة لهياكل الانتاج، والتي لا تمكّن من حركية تنموية فاعلة، فالتشكيلة العقارية للوحدات الزراعية (الحيازات) عموماً ما تكون مقسمة، اضافة الى أن كافة هذه الوحدات (الحيازات) تبقى صغيرة.
ويبقى الهدف الرئيسي من انتاج هذه الحيازات عموماً موجهاً الى الاستهلاك الذاتي العائلي، ويعتبر تعدد الأنشطة الاقتصادية (?tivitca-ylop) بالنسبة لهؤلاء المزارعين هو السبيل الوحيد، للحصول على دخل اضافي في انتظار التخلي عن أراضيهم تحت ضغط التضارب العقاري، سواء على المدى المتوسط او البعيد، بحيث ان الأهداف الرئيسية التي تتبناها أغلب هذه الوحدات الزراعية تنصب في اتجاه الاستثمار العقاري أو الارتباط الثقافي.
تعتبر الطرق والأساليب الزراعية المعتمدة عموماً محدودة الفعالية. في حين أن بعض الحيازات الزراعية تمكنت من القيام بقفزات نوعية وتقنية لها امكانات عالية من المردودية والانتاجية، مما يُظهر جلياً ان هناك هوامش كبيرة للتوصل الى مستويات تقنية واقتصادية عالية بالرغم من الكلفة المرتفعة نسبياً لوسائل الانتاج، وهذا يبين إمكانية الاستفادة من الاعتماد التدريجي على تقنيات رائدة والتي أثبتت فعاليتها ضمن ظروف ملائمة.
وأدت التكلفة العالية لوسائل الانتاج إلى ترك العديد من الأراضي الزراعية وخصوصاً الهامشية، والى تقادم سن العمالة الزراعية الدائمة، مما يطرح بقوة اشكالية البديل الذي سيحل محلها، خصوصاً ان نظام الارث يزيد من حدة المشكلة (15% من الأراضي الزراعية توجد في وضعية قانونية غير واضحة ومتنازع عليها) بالاضافة الى عدم شمولية المسح العقاري وتعدّد الأراضي غير القابلة للتجزئة (noisividni) وجمود السوق العقاري.
ومن جهة أخرى، تتّسم عمليات التسويق التي ما زالت على النمط القديم بعدم الشفافية، مما يقلص من دخل المزارع، ويحد من تفاعل الوحدات الزراعية الرائدة مع الاسواق، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على المعلومات الدقيقة والمُيوّمة المتعلقة بتعاملات الأسواق وتعدد الحواجز التي لا تمكِّن من خلق أجواء تنافسية.
شهد القطاع الزراعي تراجعاً نسبياً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولكن لم تلغ مكانته في الاقتصاد الوطني، إذ انه يؤمن:
نحو 7% من الدخل الوطني.
يشغّل ما بين 20و30% من العمالة.
يمثّل نحو 17% من قيمة الصادرات.
ويستورد لبنان جزءاً كبيراً من حاجاته الغذائية، إذ لا يغطي الإنتاج الزراعي كل هذه الحاجات، وبلغت قيمة الواردات خلال سنة 2003 نحو 2006 مليارات ليرة، ما يمثل نحو 20% من مجمل الواردات مساهمة بذلك في عجز الميزان التجاري (18% من العجز ترجع الى المواد الزراعية ومشتقاتها)، وبالمقابل لم تتعدَ قيمة الصادرات من المواد الزراعية ومشتقاتها 345 مليار ليرة. وتظهر الإحصاءات أن عجز الفاتورة الغذائية قد بلغ في المتوسط 1620 مليار ليرة ما بين سنة 2000 و2003.
إن الاستثمار على فاتورة المواد الغذائية المستوردة والتي تبلغ مستويات مرتفعة، أصبح ضرورياً لتحسين الواقع الزراعي الداخلي، وللرفع من قدرته التنافسية سواء على مستوى الأسواق الداخلية أو الخارجية.
ولا يوفر الاطار الاقتصادي العام والتوجه الاستراتيجي للاقتصاد اللبناني مناخاً ايجابياً للزراعة، خصوصاً أن ثلاثة أرباع ميزانية الدولة تخصص لخدمة الدين العام، الأمر الذي يقلّص من مستوى الاستثمارات ويحدّ من القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية في الأسواق الداخلية أو الخارجية.
تطرح الاتفاقات المتعددة المبرمة مع الدول المجاورة او في اطار جهوي (اتفاقية التيسير العربية، الشراكة الاورومتوسطية...) او الاعداد للاشتراك في منظمة التجارة الدولية، إشكالية انفتاح الأسواق ومجابهة منافسة المنتجات الخارجية، بسبب الكلفة العالية والنوعية وعدم مطابقة المواصفات، وانعدام وجود لوجيستية فاعلة للتسويق.
ويبقى المستوى المتدني لميزانية وزارة الزراعة (أقل من 0.5% من الميزانية العامة)، بما فيه المشروع الأخضر ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التابعين لها، من العوامل الرئيسية التي تحد من القيام بدور فاعل في تطوير القطاع الزراعي. كما ان الميزانية المخصصة لوزارة الزراعة والمصالح التابعة لها لا يجب ان تحجب عن نظرنا مساهمات محددة لوزارات أخرى في التنمية الزراعية كوزارة الطاقة والمياه المسؤولة عن البنى التحتية للري، وزارة المالية (التبغ)، وزارة الاقتصاد والتجارة (القمح)، وزارة البيئة (التصحّر) وغيرها من المؤسسات.
ويعتبر التنسيق بين مختلف المؤسسات جدّ محدود، ومما يزيد من حدة اشكاليات التنسيق تعدد مشاريع التنمية الريفية التي تتبناها عدة مصادر والتي تساهم نوعاً ما في شكلها الحالي غير المنسّق في تشتت العمل التنموي. إن محدودية التنسيق بين المؤسسات لا يسمح بتفعيل وبلورة قدرة البلد على الاستيعاب الرشيد لكل الامكانيات المتاحة.
يتجلى بوضوح أن القطاع الزراعي يعيش أزمة خانقة في ظل وجود بوادر التغيير وهوامش التطور الواضحة المعالم والتي لا يمكن لكل المزارعين تبنيها على نفس الطريقة. وبدون سياسة تتلاءم مع الأوضاع المختلفة، ستبقى أزمة القطاع متفشية لانه يصعب على أية زراعة حديثة ان تعرف تطوراً ملحوظاً في ظلّ النواقص الحالية التي تطبع أغلب جوانب المجال الزراعي.
وترى الاستراتيجية أنه إذا لم يتم تبني سياسة زراعية ملائمة تندرج ضمن رؤية بعيدة المدى، سيتقلص الدور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للقطاع الزراعي بشكل متزايد، ويتسبب في نفس الوقت بضياع موارد طبيعية ترتفع قيمتها باستمرار كالموارد المائية، وارتفاع الفاتورة الغذائية، وتردي الأوضاع البيئية، وتقلّص الدور الثقافي للريف اللبناني الأمر الذي سيزيد في حجم الهوة في الربط ما بين الريف والمدينة من جهة وما بين لبنان والمهجر من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق، لا يعتبر الوفير المالي التي تحقّقه الدولة نتيجة شح الميزانية المخصصة للقطاع الزراعي، ذا أثر سلبي وتكلفة عالية فقط إنما ذا أثر مدمر على المدى المتوسط والبعيد بالنسبة لكل مكونات وشرائح المجتمع اللبناني.
لذلك يجب اعتماد سياسة زراعية، ترتكز على وسائل ملحوظة وعلى رؤى قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وعلى توافق سياسي واجتماعي في إطار الإنماء المتوازن. وسيؤدي غياب سياسة زراعية واضحة الى ازدياد حدة التراجع في الانتاج سيعجز معه القطاع الزراعي عن تلبية الحاجات الدنيا للسوق الداخلي، ويترافق مع هذه الوضعية تفاقم الهجرة الريفية وتدهور متسارع للموارد الطبيعية (تآكل وانجراف للتربة، تصحّر وتبديد للموارد المائية).
أما في البدائل التي تطرحها الخطة، فتشير الى أنه يمكن توفر سياسة زراعية جريئة ترتكز على إرادة وطنية مع منح المساندة والدعم الملائمين للفاعلين في القطاع الزراعي بانبعاث جديد للقطاع الزراعي يرتكز على وحدات زراعية تتمتع بتغطية تمويلية جيدة وتعتمد على تقنيات رفيعة المستوى ذات انتاجية عالية، تؤمن الحد الأدنى المطلوب من الامن الغذائي الوطني وتزيد من حجم مشاركته في الدخل الوطني.
ولا بد من استهداف زراعة ذات تقنيات متقدمة تندرج ضمن تنمية مستدامة، وهي تستلزم تدخلاً من الدولة ومن مصادر التمويل الأخرى، ويتميّز الشكل التقني المتطور للتنمية الزراعيّة المستدامة التي تحترم البيئة بما يلي:
إنتاج ذي قيمة مضافة مرتفعة: لا بد أن يرافق اعتماد المزراعين على المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة المرتفعة عموماً زيادة في كميّات الانتاج، وتحسّن مستمر في نوعيّتها، ومتابعة عمليات ابتكار أصناف جديدة مطلوبة في الأسواق، كما لا بد أن يولى الاهتمام الكافي بالخدمات المرافقة المطلوبة التي تجعل منها منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
فعالية الجوار: يسمح موقع لبنان الجغرافي وتوفر المناطق الزراعية المتنوعة فيه (جبال، وسهول) في إطار سياسة تسويقية مناسبة له، بتوفير مساحات عمل واسعة للفعاليات المهتمة بالأنشطة المرافقة لعملية الانتاج الزراعي (البحث، التدريب، الإرشاد، المدخلات الزراعية، التصنيع والتسويق...)، كما يسهل عملية تخصص بعض المناطق على مستوى النوعية مما يخفض من تكلفة الإنتاج. وسيؤدي هذا التواجه إلى تمركز الأنشطة المرافقة، ومنح المؤسسات إمكان توسيع نشاطها ضمن الدول المجاورة انطلاقاً من لبنان.
إستعمال فاعل للأراضي (إعادة النظر في الهيكلية العقارية): من المنتظر في إطار السياسة الزراعية الجديدة أن تعرف مساحات المناطق المرويّة ازدياداً مضطرداً خلال العقدين المقبلين، لذلك من الضروري العمل على إعادة الهيكلة العقارية للوحدات الزراعية باعتماد عملية الضمّ والفرز أو زيادة مساحة هذه الوحدات عن طريق تفعيل السوق العقاري )الشراء أو الاستئجار لفترة طويلة الامد) وذلك بهدف زيادة انتاجيّة عوامل الانتاج )الموارد الطبيعية، العمل، المال) والاستعمال الامثل للموارد المالية وللاستثمارات.
حماية البيئة واستصلاح الأراضي: إن الزراعة ذات المستوى التقنيّ العالي والتي تعتمد على إمكانات مالية كافية ستسهم بشكل فاعل في الاستعمال الرشيد للمياه وفي الحدّ من التلوث الناتج عن الاستعمال غير الرشيد للمبيدات والمستلزمات الكيميائيّة، كما أنها تستدعي تكويناً وتأهيلاً وإرشاداً للمزارعين والمتعاملين مع القطاع الزراعي يجعلهم أكثر اهتماماً بإشكالية التلوث واعتماداً على الزراعة العضوية.
تأهيل العمالة: إن التطور المرتجى للقطاع الزراعي يستلزم وجود يد عاملة مؤهّلة تستطيع استيعاب زراعة ذات مستوى تقني عالٍ تؤمن ريعاً مرتفعاً وتحقيقاً لمداخيل إضافية، مما قد يسهم في اجتذاب جزء من عنصر الشباب القادر والمؤهل.
الحد من الفقر: لن يتمكن جميع العاملين في القطاع الزراعي من مواكبة القفزة النوعيّة المرتقبة للزراعة بصفة شاملة، وقد تبقى بعض المناطق المعزولة أو الهامشية خارج الحلقة التنموية المرتقبة مما يستوجب ابتكار انشطة ومصادر دخل اضافية للمزارعين وللشباب، رجالا ونساء، ووضع برامج للتنمية الريفيّة تكون مكملة للتنمية الزراعية تؤمن المساهمة المطلوبة في التماسك الاجتماعي والإنماء المتوازن.
ومن هذا المنطلق، يجب على أي استراتيجية زراعية تستهدف الوصول إلى هذا الوجه الإيجابي للقطاع الزراعي أن تتبنى فكرتين رئيسيتين، وهما:
إعادة تأهيل القطاع الزراعي.
الرفع من قدرة مختلف المتعاملين على استيعاب الإمكانيات المؤدية إلى التنمية.



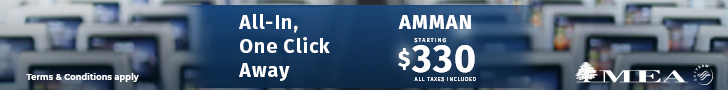

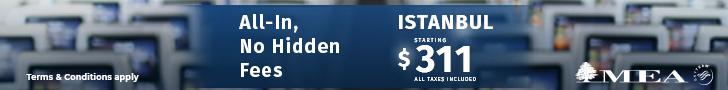
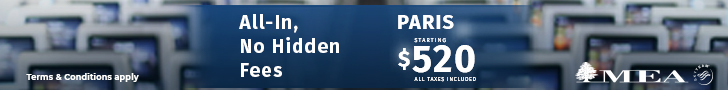



يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.