تدرس وزارة الصحة العامة الآن، نظاماً أعده مستشار الوزير محمد خليفة، بهيج عربيد، يتعلق بحوادث إسعاف الطرق، واسمه الرسمي: "نظام إسعاف الطريق الساحلي"، لأن الطريق الساحلي، من أهم الطرق في لبنان، إذ يعد مرفقاً معيشيا واقتصادياً وسياحياً مهماً، وتكثر الحوادث الخطيرة فيه، حتى أصبح يلقب بطريق الموت.
فبناء على تقدير معتدل لعدد الحوادث والضحايا والمصابين، ووفق المعلومات المتوافرة عن تكلفة كل منها، احتسب مجموع التكلفة المحسومة لحوادث المرور، التي شهدها العام 2003، أكثر من 500 مليون دولار. وإذا طبقت المؤشرات الأساسية العالمية على عدد الحوادث وضحاياها في لبنان، تزيد قيمة مجموع التكلفة، لتتعدى 750 مليون دولار. وباختصار، راوحت تكلفة جميع حوادث المرور التي وقعت خلال ذلك العام، بين 500 و750 مليون دولار، أي ما يعادل نسبة تراوح بين 3.2% و4.8% من مجمل الناتج المحلي.
إذن يدرج المشروع في إطار المسؤولية التي تتحملها وزارة الصحة لحماية الناس وسلامتهم، وتأكيد التعريف الحديث للصحة، على أنها حال من الرفاه والسعادة الجسدية والنفسية، تعمل الدولة لضمان استمرارها بالتعاون مع المجتمع المحلي ومؤسساته.
والمشروع المقترح موجه الى تنظيم خدمات إسعاف ضحايا الحوادث على طول الطريق الساحلي اللبناني، الممتد من أقصى الشمال الى الناقورة جنوباً، والبالغ طوله نحو 220 كيلو متراً، وهو يعد من الطرق السريعة، وشرياناً حيوياً بين المناطق اللبنانية كافة، إذ يجتاز معظم المدن الساحلية الكبرى، ويعد أيضا شريان تواصل تجاري واقتصادي وسياحي واجتماعي.
ويقارب عدد المواطنين المقيمين في المدن والقرى المنتشرة على طول الطريق، بنحو 65% من سكان لبنان. ويشير التقدير الى أن الآليات التي تستخدم هذا الطريق، تبلغ نحو 500 ألف آلية، وهذا يؤكد أن نسبة كبيرة من حوادث الطرق المميتة والخطرة تصيب هذا الطريق.
وغاية المشروع المقترح لهذا الطريق، هي توفير خدمات العلاج العادية والمتطورة والمنتشرة على طوله، إلا أن المطلوب تنظيمها لجعلها في متناول الجميع.
ويضع المشروع أهدافاً أساسية، أهمها: تحسين مقومات السلامة العامة على الطرق، وخفض نسب الحوادث والإصابة، وتحسين أعمال الإسعاف والإغاثة وزيادة جدواها، وتوفير شروط أفضل للمعالجة والخدمة الصحية والاجتماعية.
ويعين المشروع شركاء، منهم الإدارات العامة المعنية: وزارات الصحة والداخلية والأشغال العامة. ويمكن أن تتوسع الشراكة لتشمل وزارتي الإعلام والمال ومجلس الإنماء والإعمار.
ويضاف إلى هؤلاء نقابة المستشفيات الخاصة والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والمؤسسات الأهلية المعنية والمنظمات الدولية الداعمة.
أما العناصر المكونة للمشروع فهي:
1 ـ الإنسان بوصفه راكباً أو سائقاً أو ماراً.
2 ـ الطريق: أكانت جادة أم طريقاً رئيسيا أم فرعيا، وجسراً للسيارات أو للمشاة، ومحطة توقف أو سواها.
3 ـ المركبة: أكانت سيارة أم شاحنة أم ناقلة ركاب، دراجة أم قطارا أم طائرة.
4 ـ القانون: أكان قانون السير أم قوانين أنظمة الطرق والصيانة والمراقبة، وتلك المتعلقة بإجازة قيادة المركبات من أي نوع كانت.
5 ـ قوى الأمن المكلفة ضمان سلامة المرور.
6 ـ وسائل التدخل الطبية، أكانت وسائل الإسعاف أو الإغاثة أوالخدمات المتوافرة لدى القطاع الأهلي.
7 ـ خدمات الطوارئ المتوافرة في المستشفيات على اختلاف أنواعها.
8 ـ الجسم الطبي الذي يعد عنصراً أساسياً في نظام الإسعاف وخدمات الطوارئ.
9 ـ قاعدة المعلومات الأساسية، التي يجب أن تشمل: إحصاء حوادث الطرق وأسبابها ومواقعها وأنواعها، ومجموع تكلفة خدمات الطوارئ، وتكلفة بعض الخدمات الأساسية المساعدة في ضمان سلامة المرور، وتكلفة برامج التأهيل والتدريب الشعبي، والتكلفة الواجبة لتوفير لوازم العمل من سيارات ووسائل اتصال ومواد استهلاكية.
ويعرض المشروع الأسباب المحتملة لحوادث السير.
ويشير المشروع الى أن النظام الحالي المعتمد لإسعاف الطرق يمكن تلخيصه على الشكل الآتي: الصليب الأحمر كوسيلة إسعاف أساسية، الدفاع المدني كوسيلة إغاثة أساسية، والقوى الأمنية وتدخلها أساسي في حالات الحوادث.
والحقيقة أن تنسيقاً جيداً قائماً بين هذه الأجهزة الثلاث والتي يمكن أن تستعين بخدمات البلديات أو الإطفائية أو سواها عندما تدعو الحاجة.
ويلفت الى أن مشاكل حقيقية تواجه عمليات الإسعاف أهمها: العلاقة مع المستشفيات، أنظمة تغطية الكلفة والضعف في الإمكانات المتوفرة عند وقوع الحادث، والمشكلة تتفاقم إذا كان الحادث كبيراً أو الإمكانات الممكن توفرها.
ويضيف أن مشكلة الصليب الأحمر اللبناني تكمن في الإسعاف النهاري حيث مثلاً لا تتوفر لمدينة بيروت إلاّ فرقة تدخل واحدة، إنهم يعملون حالياً على تحسين الوضع، خصوصاً وإن مساعدة مالية كبيرة تقدم لهم من قبل وزارة الصحة لدعم خدمات الإسعاف وبنوك الدم.
ويقترح المشروع حلولاً لخفض معدلات الحوادث، ومنها معالجة المشكلات المرتبطة بحال الآلية والتأهيل المستمر للسائقين.
كما يعوّل أهمية كبيرة على معالجة الطرق، إذ أن أهم ما يمكن معالجته لتأثيره المباشر على السيارة وتوازنها ويشكل عناصر مهمة في عملية التخفيف من معدلات الحوادث:
ـ وجود الحفر، خصوصاً التموجات على الطرقات السريعة والتي تفقد السيارة الكثير من توازنها وتؤسس مع عناصر أخرى لوقوع الحادث.
لا بد أيضاً من معالجة المطبات والتي تأخذ أشكالاً وأحجاماً مختلفة.
ـ معالجة مداخل ومخارج الأوتوسترادات.
ـ تنظيم المواقف على جانبي الطريق السريع، فالتوقف حالياً عشوائي لوسائل النقل المشترك وللسيارات العمومية والخصوصية.
فلا بد من تحديد مواقف ثابتة لوسائل النقل المشترك مع لحظ مساحة أمان ومداخل ومخارج آمنة لهذه المواقف للسيارات وللمواطنين.
ـ تنظيم تواجد المؤسسات على جانبي الأوتوسترادات من محال ومعارض وشركات ومدارس وسواها.
إن منظر الأوتوسترادات لدينا فريد من نوعه، خصوصاً عندما يقترب أو يخترق المدن حيث تتشابك الأمور (السيارة المسرعة وعجقة المحال والسيارات المتوقفة على جانبي الطريق إلخ..).
ـ مراقبة حمولة الشاحنات على أنواعها صغيرة كانت أم كبيرة، فللسيارة طاقة تحمل وعندما تتخطى طاقة احتمالها ومع السرعة الكبيرة للشاحنات، خصوصاً وأن الطريق هو ساحلي ويساعد على السرعة. فمع السرعة ومع حمولة فائضة تصبح إمكانات التوقف المفاجئ شبه مستحيلة، إضافة لإمكانات تعطل الفرامل وانفجار الإطارات، كما أنه يحدد عدداً من الإجراءات التي يجب أن تستهدف المواطنين، ومنها:
* المطالبة بالتعامل بجدية كاملة من قبل الأجهزة المسؤولة في وزارة الداخلية مع تعلّم قيادة السيارات وحيازة الترخيص في القيادة أو التجديد لها.
* التشدّد في مراقبة السير والعقوبات المفروضة على المخالفات. ويجب أن نفرق بين مخالفات قد تسبب ازدحاماً في السير ومخالفات يمكن أن تسبب حوادث خطيرة ومميتة كالتجاوز في أماكن غير مسموح بها التجاوز أو اجتياز الضوء الأحمر أو الوقوف في أماكن خطرة... إلخ.
* التشدّد في مراقبة السرعة ومراقبة مستوى الكحول في الدم... إلخ وأن تكون المراقبة دائمة ومستمرة.
* تكثيف حملات التوعية الموجهة للشباب بنوع خاص وحتى لتلامذة المدارس الابتدائية والثانوية وتعريفهم بقوانين السير والإشارات على أنواعها، خصوصاً توضيح مخاطر الحوادث وما قد تسبّبه من مآسي وإعاقات جسدية وسواها. ويمكن لمؤسسات القطاع الأهلي ولوزارة التربية وبالتعاون مع وزارة الداخلية القيام بمثل هذه المسؤوليات.
* حماية التلامذة أثناء انتقالهم من المنزل الى المدرسة ومن المدرسة الى المنزل، ومراقبة الأوتوكارات الخاصة بالتلاميذ، خصوصاً مراقبة مداخل ومخارج المدارس.
ويشدد المشروع على أهمية تعزيز إمكانات إسعاف الطرق وأعمال الإغاثة، ويلفت الى أنه لتحقيق ذلك، لا بد من توفر مجموعة شروط، منها، تقرير أي نظام إسعاف نريد لارتباطه بشروط خاصة بكل نظام ولارتباطه من جهة ثانية بالتكلفة المترتبة.
ويدعو المشروع الى ضرورة اعتماد مركز واحد لإدارة عمليات الإسعاف، ويقترح أن يكون مركزه في بعبدا، وتكون مهمته:
ـ استلام طلبات المساعدة noitpecer ed ertneC
ـ القيام ومن خلال المعلومات الأولية المتوفرة بتصنيف الحالة الطارئة egairT وإعطاء الأوامر لوحدة الإسعاف أو لوحدات الإسعاف إذا كان الحادث يتطلب ذلك للتحرك ednammoC.
ـ بقاء المركز على اتصال بوحدة الإسعاف لتبيان حقيقة الوضع ولتوجيه الإسعاف على ضوء ذلك للمستشفى الملائم noitatneirod eloR.
إن حسن قيادة العمليات إضافة لحسن التنظيم ولفعالية نظام الاتصال كفيل باختصار الوقت وحماية المواطن.
أما بالنسبة للخدمة في أقسام الطوارئ في المستشفيات بالنسبة للمصابين بحوادث السير، فيشير الى أنها تخضع لمجموعة شروط أهمها:
ـ تحديد حجم الحاجة في مجال الطوارئ وحوادث الطرق بنوع خاص لخدمات أقسام الطوارئ في المستشفيات. تقدير كمي.
ecnegrud ereitam ne snioseb sed evitatitnauq noitaulavE.
ـ تحديد أنواع الإصابات التي:
* لا تتطلب دخول المستشفى وهي تتلقي الخدمة في قسم الطوارئ وتخرج tuO.
* تتطلب دخول المستشفى وهي تقدر بنسبة 15% من إجمالي الحوادث. المشكلة إن القسم الأكبر من الإصابات في حوادث السير هي كسور متنوعة المواقع والخطورة ولا توجد لدينا إحصاءات عن نسبتها.
* تحديد حجم الحاجة لمراكز الطوارئ لتلبية الحاجة خاصة في الحوادث عموماً وحوادث الطرق خصوصاً.
ويلفت الى ضرورة الأخذ في الاعتبار نمو القطاع العام الاستشفائي وضمن أفضل المقاييس العالمية واعتباره جزءاً من نظام الطوارئ.
ولا بد أيضاً من اعتماد نظام إحالة واضح بين الفئآت الثلاث من المستشفيات المعتمدة في نظام الطوارئ.
ولا بد كذلك من إجراء عملية تقويم دورية لأقسام الطوارئ noitatidercA للتأكد من مدى محافظتها على شروط النوعية والسلامة العامة المفروضة على أقسام الطوارئ.
وأخيراً لا بد من اعتماد تعرفة خاصة بخدمات الطوارئ NI أو TUO وأن تعتمد من قبل المؤسسات الضامنة ووزارة الصحة والمستشفيات.
في النهاية إن جوهر المشكلة هنا تكمن في حسم من يدفع فاتورة الخدمة الطارئة في المستشفيات ويظهر أن مشروع التأمين الإلزامي للسيارات لم يعط النتائج المرجوة، فلا بد من إعادة درسه وتقويم تطبيقه واكتشاف مواقع الخلل فيه لتصويبها.
وإذ يلاحظ المشروع أن التكلفة لن تكون باهظة لاعتماد مثل هذا النظام، فإن يتطلب:
* إعادة تقويم لمشروع التأمين الإلزامي للسيارات وللتأمين على ورش العمل وسواها وتصويبها وبما يتلاءم ومصالح المواطنين.
* تعديل بسيط في حجم الأسرة المتعاقد حولها مع المستشفيات لمعالجة المواطنين على نفقة الدولة. ولا ننسى إن كل سرير تعاقدي يكلف الدولة نحو ستين الف دولار سنوياً. فالأمر يتطلب أكثر من تخفيض نحو 50 ـ 100 سرير تعاقدي لتغطية أية نفقات ناتجة عن نظام الطوارئ.



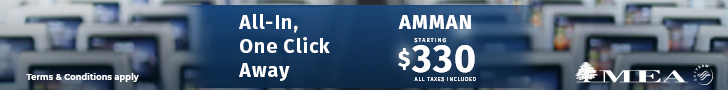

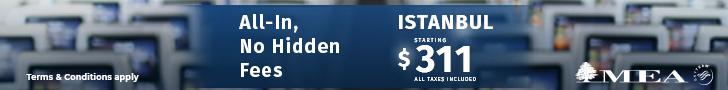
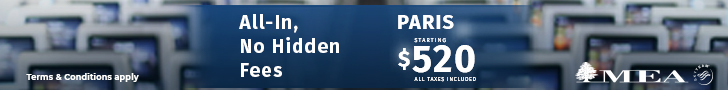



يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.