تراهن وزارة الصحة العامة، على القانون المقترح للخريطة الصحية، لاعادة تنظيم القطاع الصحي في لبنان، عبر تنفيذ دراسة وطنية حول الحاجات الصحية للمواطنين في مخلتف المستويات والأنواع، واعتماد مقاييس لكل حاجة صحية لتشكل الأساس لتنظيم السوق الصحية الإستشفائية والرعائية، ولتشكل الأساس أيضاً لكل سياسة تنموية وللأولويات التي يمكن اعتمادها في مجالات الصحة المختلفة، كما تهدف الخريطة الى ضبط الانفاق الصحي المقدر بـ12.3% من حجم الدخل القومي أي بحدود الملياري دولار سنوياً، اذ يؤمن القانون المقترح مع بعض التوجيهات الحديثة في كل ما يرتبط بهذا القطاع (الدواء ـ مختبرات ـ الجسم الطبي وغيره) خفضاً بنسبة 30% من هذه التكلفة، أي نحو 600 مليون دولار سنوياً.
وينقسم القانون المقترح الى مراحل ثلاث، هي:
1 ـ مرحلة الخريطة الصحية: قياس الحاجة لأي مشروع صحي مزمع إنشاؤه.
2 ـ مرحلة الإنشاء: فرض الشروط الفنية على الإنشاء.
3 ـ مرحلة الاستثمار، وتشمل: نوعية أنظمة الإدارة في المؤسسة المزمع إنشاؤها، والخدمات الطبية التي ستقدمها، والجودة المطلوبة.
وعلى الرغم من طرح الموضوع منذ سنوات عدة، فإن وزارة الصحة تجهد الآن لتحويل مشروع القانون المقترح من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، بعد أن أخذت موافقة مجلس شورى الدولة، على الرغم من التعديلات المطلوبة على عناصره الأساسية، ومنها تحديد مفاهيم المنطقة الصحية، مقاييس الحاجة، نظام الاعتماد الذي صدر قبل 3 سنوات، المقاييس الفنية لمختلف أقسام المستشفيات، المواصفات الفنية للمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات، وتوضح الوزارة أنه في هذا السياق، قد سبق للجان المختصة في الوزارة أن وضعت مع الاستشاري القانوني المختص، مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون، وهي بامكانها حل العديد من التعديلات المطلوبة.
أما العقبات الأخرى، فتتمثل في معارضة مؤسسات ومراكز صحية، كانت تستفيد من الفوضى التي تفشت في القطاع، خلال سنوات الحرب، فضلاً عن عقبات تتمثل في ضعف المعلومات المتوافرة عن القطاع، لكن العقبة الأهم تكمن في القرار السياسي، الذي يجب أن يكون واضحاً لجهة استيعاب ما يمكن أن تقدمه الخريطة من تنظيم ووفر في هذا القطاع الحيوي، لأن المشكلة فيه ليست في حجم الإنفاق وبقدر ما هي في سياسة ترشيد هذا الإنفاق.
اذ يعتبر المستفيدون من وضع القطاع بحاله الراهنة، أن الوزارة تسير بهذا القانون المقترح "عكس السير"، ففي حين يتجه لبنان بالقطاعات الخدماتية نحو الخصخصة، يعاكس القانون هذا التوجه، ويمشي لضبط السوق الصحية وتقييدها، وهو ما يخالف في الأصل النظام الاقتصادي الحر المعمول به في لبنان، لا بل يقف عائقاً في وجه المبادرة الفردية، التي تشكل مرتكزاً لنمو الخدمات الصحية، كما هو الحال في فرنسا وانكلترا وشمال افريقيا.
ويؤكد الاستشاري في وزارة الصحة الدكتور بهيج عربيد، أن القانون المقترح للخريطة، سيسمح بدراسة الجدوى الاقتصادية والطبية لإنشاء أي مستشفى أو مركز خدمات صحية، والتي على ضوئها سيتقرر الموافقة أو عدمها أو اقتراح تعديل في المشروع.
ويقول "إن الوزارة لا تسير عكس السير في لبنان، خصوصاً أن نظامنا الصحي قام في الأساس على المبادرة الفردية والاقتصاد الحر، والدليل أن المستشفيات الخاصة قد قامت بجهد جبار خلال الأحداث الطويلة التي مر بها البلد. إن الخريطة الصحية هدفها حماية الاستثمارات الخاصة في مجال الصحة، وفي الوقت نفسه منع كل أشكال الفوضى والمضاربة غير المبررة، لقد أصبحت الخريطة أهم مطلب لدى نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة".
ويؤكد عربيد أن الخريطة الصحية أداة اعتمدتها فرنسا في السبعينات، وحدّدت على أساس أنها وسيلة معلومات وتخطيط لتنظيم القطاع الصحي، وهي توجه في السياسة الصحية، لتعديل معادلة العرض والطلب، والإنطلاق بتنظيم السوق من خلال الأهداف التي وضعت في الخريطة، التي يجب أن تؤمن متطلبات عدة منها: معرفة ماذا يملك لبنان من تجهيزات وخدمات ومراكز طبية، معرفة الحاجات وماذا يريد المواطن، ومعرفة كيفية التوزيع العادل في الخدمات على جميع المناطق، وجعل الخدمة الصحية في متناول جميع الناس.
ويشير الى أن الخريطة الصحية "لها مرتكزات، من أهمها تلك التي اعتمدت في التطبيق في فرنسا وكانت أول من طبقها في سبعينات القرن الماضي، وعدد من الدول الأوروبية، وهي:
1 ـ مجالات التطبيق: يمكن تطبيق الخريطة في جميع ميادين وحقول الصحة، بدءاً بالرعاية الصحية وانتهاء بتنظيم المراكز الصحية والخدمات الأساسية، وصولاً الى التنكولوجيا الطبية المتطورة في مختلف الحقول".
"يضاف الى ذلك جميع الخدمات التي هي خارج موضوع الاستشفاء مثل المختبرات والجسم الطبي.
2 ـ المنطقة الصحية: تنظيم الصحة ضمن مشروع الخريطة من خلال ما يُعرف بالمنطقة الصحية، وقد حددت المنطقة الصحية بما يتناسب والنظام الإداري المعمول به الآن.
وكل مستوى من هذه المناطق مرتبط بالخدمة التي ستحدد، وهذا التوجه يعكس تعزيز اللامركزية في إدارة الصحة، فجميع الأنظمة التي طبقت في الخريطة تتوجه الى المراكز الصحية في المناطق، وقد انشئت لهذه الغاية مجالس للصحة على مستوى المنطقة الصحية، مؤلفة من ممثلين من مختلف القطاعات (وزارات، صناديق تأمين، ضمان، نقابات والقطاع الأهلي).
وقد أعطيت مجالس المجموعة هذه، صلاحية اقتراح المشاريع والخطط، وتحديد الأولويات والحاجات ووضع الموازنات السنوية للعمل الصحي في المنطقة.
3 ـ جودة الخدمات الصحية: وهذا المرتكز يرتبط بتقديم الخدمة وشروط الجودة، وقد بدأت في وزارة الصحة بتطبيق نظام الاعتماد على المستشفيات منذ 3 سنوات، وهو نظام محدد لشروط السلامة العامة الواجب اعتمادها في المستشفيات".
"وينص هذا النظام على ضمان الجودة في انتاج الخدمات، وقد بدأنا بتطبيق هذا النظام منذ أكثر من 3 سنوات، والنتائج حتى الآن مشجعة".
ويلفت عربيد الى "ان لدى لبنان الآن نحو 140 مستشفى خاصاً مع 10 آلاف سرير، وسيكون هناك نحو 32 مستشفى حكومياً مع 2715 سريراً، وأصبح هناك نحو 23 مركزاً للقلب المفتوح و45 للرنين المغناطيسي، أي بمعدل آلة لكل 150 ألف نسمة، وهناك 90 مركزاً للتصوير الطبقي المحوري، أي بمعدل آلة لكل 55 ألف نسمة، وإذا ما قارنا هذه الإمكانات مع دولة مثل فرنسا، نجد أنه في مجال القلب المفتوح، يوجد في فرنسا مركز لكل 800 آلف نسمة، وفي مجال تفتيت الحصى هناك آلة لكل مليون مواطن مقابل آلة لكل 220 ألف نسمة في لبنان. البعض يدافع عن هذا الواقع، وذلك يعود الى السماح بالمبادرة الفردية وأن أي استثمار في قطاع الصحة، مسؤولية يتحملها صاحب العلاقة، وفي رأينا ورأي الدول المتقدمة قبل الفقيرة، إن هذا الأسلوب خطير، لانعكاس ذلك على السوق الصحية في لبنان، وتكاليف الصحة، وخصوصاً في أجواء مثل لبنان، والتي تجعل من الرقابة عملية محدودة وتجعل من إمكانات ضبط السوق عملية صعبة".
ويشير عربيد الى أنه "في مناقشة حديثة جرت في وزارة الصحة، شارك فيها كل من وزير الصحة العامة محمد خليفة، المدير العام للوزارة وليد عمار وجميع أركان الوزارة، اتفق مبدئياً على اعتماد الليونة في مفاهيم المنطقة الصحية، خصوصاً أن المحافظات تتفاوت بشكل كبير في المساحات، وكذلك في عدد السكان، فمن 1.5 مليون نسمة في جبل لبنان الى 500 ألف في محافظة البقاع، ويضاف إلى هذا الواقع أن بعض التجمعات السكانية في لبنان، تمثل ثقلاً سكانياً خاصاً، فمثلاً الضاحية الجنوبية للعاصمة، وحدها أكبر من محافظة من حيث الكثافة السكانية، ولذلك ينبغي أن لا نكون مجمدين عند دراسات للأسرة الاستشفائية بمفهوم المحافظة.
4مقاييس الحاجة: إن الخريطة الصحية من حيث المبدأ تتوجه لتنظيم العرض من خلال الحاجة للخدمات الصحية، وهذا يفترض أن تتوفر لدينا في لبنان تقديرات ذقيقة حول حاجتنا لجميع أنواع الخدمات الصحية والتكنولوجيا الطبية المتطورة، ولقد اعتمدت الدول التي نفذت الخريطة الصحية وفي المقدمة فرنسا، مقاييس لكل حاجة أو تكنولوجيا مطلوبة، كأن نقول إن حاجتنا هي لـ3 أسرة استشفائية قصيرة لكل ألف مواطن، أو آلة رنين مغنطيسي لكل 200 ألف نسمة. فلبنان يعتبر بلداً مستهلكاً للخدمات وللتكنولوجيا وليس مصنعاً لها، وبالتالي لنا مصلحة في أن نضبط هذه التكنولوجيا المتطورة والمكلفة في آن، وذلك لانعكاسها الأكيد على تكلفةالصحة.
ويقول عربيد "إن عدم الوضوح هذا يفرض علينا أن نكون مرنين جداً في اعتماد مقاييس الحاجة، التي تنظيم السوق الصحية، فالمطلوب منا أن نوفق بين ضبط السوق ووقف الانفلاش الأفقي للخدمات المتطورة، وحاجات المواطنين وتطورها".
ويضيف انطلاقاً من مسألة تحديد مفهوم المنطقة الصحية وقياس الحاجة، أطرح معادلة، تقوم على الجمع بين قياس الجودة والقياس السكاني وبعض التوجهات الحديثة في السياحة الصحية، فمثلاً هناك انفلاش أفقي في مراكز عمليات القلب المفتوح في لبنان، اذ يبلغ تعدادها 23 مركزاً، وهذا يمكن أن ينعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، لأن حجم تشغيل هذه المراكز يتفاوت كثيراً بين مركز وآخر، حيث توجد مراكز لا تجري أكثر من 50 عملية في السنة، وفي بعض الدول فإن هذا الحجم من الانتاج يتطلب اقفال المركز".
ويوضح "نحاول في الوزارة ومن خلال توجيهات وزير الصحة، على اعادة تنظيم السوق المحلية وضبط الانفلاش الحاصل الآن، بالإضافة الى اعتماد توجهات حديثة في تنظيم هذه السوق، واذا كنا في لبنان نملك امكانات ضخمة من الخدمات وبمستوى جيد، فإنه في نفس الوقت مكلف على المستوى الوطني، وهو ما يتعارض مع الواقع الاقتصادي والمالي الذي يعيشه البلد، فحجم الانفاق الصحي هو الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، ويساوي ثلاثة أضعاف ما تنفقه دول مجلس التعاون الخليجي على الصحة، وذلك نسبة الى الدخل الوطني".
ويرى عربيد "ان الصحة هي أولاً قرار سياسي، لأنها باتت من القضايا الأساسية في المجتمعات النامية والمتقدمة".



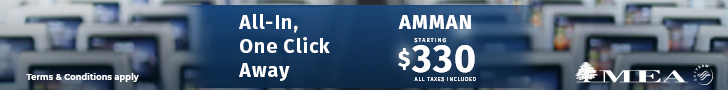

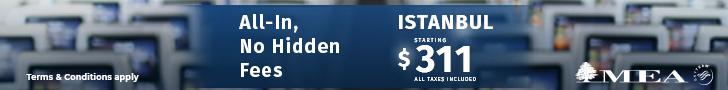
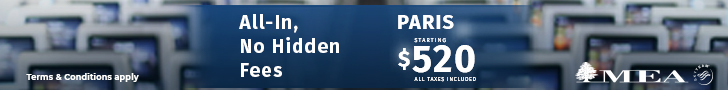



يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.