اذا كانت وزارة الصحة العامة تتبنى في أولويات سياستها الصحية، وضع خطط من شأنها خفض الانفاق الصحي، الذي يشكل 11% من مجمل الناتج القومي، وهو رقم قياسي بالمقارنة مع حجم لبنان وتعداد سكانه، إلا أنه وبشيء من الغرابة لا يسد الفجوة الرقمية لتدهور القطاع الصحي في هذا البلد، عندما نعلم أن هناك نحو 40% من اللبنانيين ليس لديهم أي تغطية اجتماعية، تؤمنها الدولة لهم.
واذا كان القطاع الصحي في لبنان مصابا بداء الترهل في معظم مرافقه، فهو دون أدنى شك على وشك الانهيار إن لم تبادر الوزارة المعنية بلملمة هذه المرافق، واعادة تصويب سياستها لتفعيل القطاع، وابراز دوره الحيوي والحياتي على المستوى الوطني، انطلاقاً من وقف الهدر وصولاً الى تأمين السلامة العامة لكل فرد في هذا البلد.
ولأن سياسة ترشيد الانفاق الصحي، تتطلب وضع الاصبع حيث الجرح والنزف، فإن توحيد السياسة التأمينية في لبنان من خلال توحيد الصناديق الضامنة، (التي تشكل هدراً بشرياً ومادياً مع تعدد اداراتها وأجهزتها والفروق في تكاليفها الاستشفائية لوجود امتيازات قانونية خاصة بكل منها)، يشكل علامة فارقة في مستقبل القطاع اذا ما تحققت أو كتب لها السياسيون أن تتحقق، خصوصاً أن أي قرار في لتصحيح السياسات المعتمدة يتطلب في لبنان تحديداً توافر الارادة السياسية الواضحة والصريحة للبدء بذلك.
ولكن السؤال هل يمكن تحقيق ذلك، وما هي الحلول المقترحة؟
يؤكد مدير وحدة التخطيط في وزارة الصحة بهيج عربيد، أن الحلول المقترحة ممكنة وواقعية، شرط توافر الارادة السياسية، وشرط اعتماد المراحل في عملية التطبيق، على أن يتزامن ذلك مع تبني خطة تنفيذية لتصحيح مسار كل القطاعات الصحية الاستشفائية والرعائية والقوى الصحية العاملة وسواها، لأن أي خلل في أي منها سينعكس سلباً على الباقي.
يشير عربيد الى أن المراحل المقترحة للحلول، هي:
المرحلة الأولى
1توحيد آليات عمل الصناديق، مثل توحيد التصنيف المعتمد للمستشفيات الخاصة والعامة، حيث يتوجب تنفيذاً لمرسوم الاعتماد، على الصناديق الضامنة بما فيها وزارة الصحة ألا تتعاقد إلا مع المستشفيات المعتمدة مهما كانت الظروف.
2توحيد تعرفات الأعمال والخدمات الاستشفائية على مختلف أنواعها، وتوحيد نظام البدل المقطوع للأعمال الجراحية مستنداً إلى بروتوكول طبي لكل عمل، على أن يكون مرتبطاً بالتعرفة المقطوعة.
3توحيد مضمون الاتفاقات مع المستشفيات الخاصة والحكومية بالتعاون والتفاهم مع نقابتي الأطباء والمستشفيات، وتوحيد آليات الرقابة على المستشفيات لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقات.
4معالجة دور وزارة الصحة في مجال التأمينات الصحية، اذ إن الوزارة قد اضطلعت بدور ليس لها، خصوصاً خلال فترة الأحداث الأليمة (19771978)، في تأمين المعالجات الطارئة. ويرى عربيد أن تقدم معالجة سياسة التأمينات الصحية سيدفع الوزارة لأخذ دورها في مجال رعاية السياسة الصحية، وتنظيم أسواق الخدمات الاستشفائية والرعائية وسوق الدواء، بالإضافة الى مراقبة الجودة والسلامة العامة ومراقبة حركة الأمراض ومعالجتها.
ويضيف أن الواقع الحالي للتأمينات الصحية العامة تشكل أساساً جيداً لهدر الجهد والامكانات، وفي هذا الاطار، يمكن طرح توجهات عدة، لمعالجة هذا الأمر:
ـ التوجه الأول: يتمثل بإنشاء مؤسسة عامة مستقلة، للقيام بأعمال المراقبة على المستشفيات العامة والخاصة، يشارك في ادارتها ممثلون عن كل الصناديق الضامنة، على أن ترتبط حكماً برئاسة الحكومة، وأن توضع لها موازنة تشغيلية خاصة.
ـ التوجه الثاني: تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (كونه أكبر الصناديق العامة الضامنة)، بمهمة المراقبة لجميع المرضى المعالجين في المستشفيات لمختلف الصناديق (إلا أن هذا الحل سيواجه باعتراضات أساسية من باقي الصناديق).
التوجه الثالث: تلزيم أعمال المراقبة الطبية والادارية لمؤسسة محلية أو عالمية متخصصة في هذا النوع من الأعمال.
ونحن نعتقد أن الاقتراح الثالث هو الأفضل، لكونه يحرر ادارة الصناديق من هذه المهمة، لتتفرغ لتحسين مستوى الخدمات، وتطوير السياسات خدمة للمضمونين، ولكن اعتماد أي من هذه الاقتراحات، سيؤدي حكماً الى وفر أكيد في الأداء والنتائج.
المرحلة الثانية
مرحلة البطاقة الاستشفائية
للبدء بتنفيذ هذه المرحلة يقول عربيد يفترض أن نكون قد نفذنا وثبتنا المرحلة الأولي، خاصة مفهوم العمل المشترك للصناديق الضامنة كما ثبتنا القرار السياسي وطورناه باتجاه المراحل اللاحقة.
ويشرح عربيد رؤيته كالآتي:
ما هي الأسباب الموجبة للبطاقة الاستشفائية، ولماذا البطاقة الاستشفائية والجميع يتحدث عن بطاقة صحية؟
نعتبر ان كل الشعب اللبناني يتمتع بتغطية صحية للخدمات الاستشفائية وهي موزعة على الشكل التالي:
ـ مؤسسات ضامنة عامة 51 في المئة
ـ مؤسسات ضامنة خاصة 8 في المئة
ـ وزارة الصحة 41 في المئة
ومع تفاوت في معدلات الاستفادة
ـ القوى العسكرية 100 في المئة
ـ ضمان تعاونية 90/10
ـ وزارة صحة 85/15
ـ ذوو العهدة التعاونية 75/25
وان تفاوتاً حاصلاً أيضاً في درجات المعالجة
ـ وزارة الصحة درجة وزارة
ـ الضمان درجة الضمان، وهي بين الثانية والثالثة.
ـ الضباط ـ موظفو الفئات الأولى والثانية والثالثة درجة أولى هذا التفاوت في الدرجات أنتج حكماً تفاوتاً في تكلفة اليوم الاستشفائي، الذي يراوح بين 285 ألف ليرة لمريض الضمان وصولاً لنحو 550 ألفاً لمرضى المؤسسات العسكرية.
ولا بد من الاقرار بأن توحيد قاعدة المعلومات بين الصناديق الضامنة سيساعد في تنفيذ هذه المرحلة.
ماذا يمكن أن نوحد في هذه المرحلة:
أ ـ أن نعتمد الضمان الاجتماعي كأساس لهذا المشروع يعني أن يكلف الضمان التنفيذ.
ب ـ ان نلغي دور وزارة الصحة العامة في تأمين الخدمات الاستشفائية للمواطنين غير المستفيدين من أي تقديمات خاصة أو عامة.
وان يسند هذا الدور الى الضمان الاجتماعي.
ج ـ تعاونية الموظفين
يمكن دمج مرضى التعاونية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذه المرحلة يمكن ترك موضوع التعاونية للمرحلة اللاحقة ولسببين الأول ان الضمان سيتعامل مع نحو 70 ـ 75 في المئة من الشعب اللبناني، وهو عدد ضخم يفترض اعطاء الضمان الوقت لكي يبني امكاناته الادارية والفنية لادارة العملية.
والسبب الثاني، أن مرضى الوزارة هم الأقرب الى الضمان من مرضى التعاونية، حيث توجد امتيازات خاصة بفئات الموظفين والتي نؤكد ان مشروعنا يحافظ عليها كمكسب وطني للموظفين، وحتى لا تشكل هذه الامتيازات تعقيدات للضمان في تعامله مع المستشفيات والمرضى.
نحن نفضل ان تبقى التعاونية خارج هذه المرحلة.
د ـ المرضى العسكريون وذووهم:
نحن نعتقد بضرورة المحافظة على الخصوصية العسكرية، ومن هذا المنطلق ننادي بضرورة تطوير امكانات المستشفى العسكري اما عائلات العسكريين فيمكن بحثها مع القيادة العسكرية اذا كان ممكناً ضمهم للضمان الاجتماعي.
وفي مطلق الأحوال، ليس سيئاً أن ننطلق في هذه المرحلة ببطاقة استشفائية لنحو 70 في المئة من الشعب اللبناني.
هـ الضمان الاختياري للمواطنيين
ان البدء بتطبيق البطاقة الاستشفائية الموحدة يلغي منطقياً الحاجة لضمان اختياري لتغطية الخدمات الاستشفائية في حين تبقى هذه الحاجة موجودة لتغطية الخدمات خارج الاستشفاء كون وزارة الصحة العامة لا تغطي الخدمات خارج الاستشفاء. هذا يعني أن نحو 40 في المئة من المواطنين لا يزالون بحاجة الى تغطية غير متوافرة للخدمات خارج الاستشفاء. والكل يعلم ان مشكلة الانفاق الصحي تقع في الواقع خارج الاستشفاء، حيث إن معدل الانفاق يبلغ نحو 60 في المئة من مجمل الانفاق الصحي، وان نحو 71 في المئة منه تغطيه موازنة العائلة مباشرة.
(والمشكلة هنا هي في كيفية التوفيق بين هذين الأمرين).
البدء بتطبيق الضمان الاختياري، اعتقد البعض اننا بدأنا بسياسة جديدة مميزة، واننا بدأنا بتصحيح مسار سياسة التأمينات الصحية. ولكن ماذا حدث؟ يظهر أن غالبية الذين تقدموا للضمان الاختياري كانوا من المتقدمين في السن، وممن هم بحاجة للمعالجة في المستشفى وخارجها ولنتذكر فقط ان معدل الحاجة للخدمات العلاجية على انواعها هي تقريباً 6 مرات أكثر عند المتقدم في السن (بعد الستين) منه عند الشباب.
ثم توقف المشروع بسبب التكلفة المرتفعة، والضمان يعتمد في التوازن المالي لديه على معدل الاحتمالات. فعندما يكون غالبية المضمونين هم في حكم المرضى فهذه كارثة حقيقية على المؤسسة الضامنة.
ماذا تستطيع ان تقترح للتوفيق بين الواقع حيث تتوفر الخدمات الاستشفائية للجميع (وأصبحت شبه مجانية في المستشفيات الحكومية المستقلة 5 في المئة فقط من الفاتورة يدفعها المواطن). والحاجة لتأمين التغطية للخدمات خارج الاستشفاء.
نحن نعتقد أن البدء يكون بدراسة واقعية جدية للتكلفة الحقيقية في الضمان الاجتماعي للاستشفاء، ومعدلات الحاجة لمختلف الفئات العمرية وللخدمات خارج الاستشفاء التشخيصية والعلاجية، والمتابعة مع ضرورة أن نفترض ان يتولى الضمان حماية زبائنه في تعامله مع الأطباء والمؤسسات العلاجية والاستشفائية.
وفي ضوء هذه الدراسة، نستطيع أن نكون فكرة واضحة عن تكلفة الخدمات الاستشفائية حيث تتولى وزارة الصحة العامة تغطية هذه التكلفة وبالتالي منطقياً نقرر ماذا يمكن ان يتحمل المواطن منها، ونكوّن فكرة ايضاً حول تكلفة معالجة 40 في المئة من الناس خارج الاستشفاء.
أو أن نقوم بعملية حسابية أخرى، منطلقين من دراسة الضمان الاجتماعي حول تكلفة التأمين الصحي لكل مواطن وتحتسب عندها التكلفة الاجمالية لـ 40 في المئة من غير المضمونين.
يقول المسؤولون في الضمان الاجتماعي أعطونا موازنة الخدمات الاستشفائية التي تقدمها وزارة الصحة ونحن نتكفل بتغطية الـ 40 في المئة اسوة بالمضمونين.
وبالتالي واستناداً لما سبق ذكره، نعتقد أن ما سمي التأمين الاختياري لا معنى له بالطريقة التي طرح فيها لأن المواطنين عندما اقدموا على التأمين الاختياري كانوا عملياً بضمنون الخدمات خارج الاستشفاء، الأمر الذي جعل فقط فئة المتقدمين في السن يعانون مشاكل صحية متعددة، تتطلب فحوصاً تشخيصية شعاعية ومخبرية، وكميات متنوعة من الأدوية.
ولو استمر التأمين الاختياري لكان ادى حكماً الى كارثة مالية في الضمان الاجتماعي.
و ـ التأمين الالزامي على السيارات (وشاغلي السيارات من سائقين وركاب): كان من المفترض ان يؤدي هذا التأمين الى حل مشكلة في غاية الأهمية الا وهي معالجة الحالات الطارئة الناتجة عن حوادث السير في المستشقيات. ولكن يظهر، ومن خلال التجربة فشلُ هذه العملية، فشركات التأمين تجد في قانون السير غير الواضح الأسباب الكافية للتهرب من دفع المستحقات للمستشفيات، ويبقى المصاب عالقاً، والمستشفى لا يعرف من يدفع الفاتورة، ويمكن أن يموت ناس دون أن يتمكنوا من ايجاد مستشفى يقبل معالجتهم.
نحن نعتبر ان التأمين الالزامي على السيارات وعلى ورش العمل كافة، ولكافة العاملين ولأي جنسية انتموا أمر في غاية من الأهمية، وعليه فإننا نطالب الوزارات المعنية من داخلية وعدلية وعمل اعادة تقويم التجربة وتصحيح الأوضاع.
س ـ التأمين والرعاية الصحية الأولية
تمثل الرعاية الصحية الأولية التوجه الأساسي في السياسة الصحية لتصحيح مسار السياسة الصحية، وترشيد الانفاق الصحي. لا يمكن الاستمرار بسياسة ضمان المرضى من قبل صناديق التأمين العامة كما هو حاصل حالياً، حيث كل الجهود والامكانات تصرف لتأمين معالجة المستفيدين من التأمينات العامة في المستشفيات ام خارجها، وبالتالي لا تقوم هذه الصناديق بأية جهود ولا تصرف اي موازنات لتنفيذ برامج رعائية وقائية وعلاجية.
وما يمكن اقتراحه في هذا المجال هو على سبيل المثال لا الحصر
1 ـ أن تمتلك المؤسسات الضامنة العامة مؤسسات رعائية متطورة اي مراكز صحية في كافة المناطق.
وتحدد المواصفات الفنية والادارية والطبية لهذه المراكز بشكل يسمح بتقديم خدمات تشخيصية (أشعة ومختبر) أساسية، وخدمات علاجية (اختصاصات طبية متنوعة خاصة اطفال ونساء وطب العائلة والقلب والشرايين والجلد والعيون والأنف أذن حنجرة وسواها)، وتقديم خدمات طب الأسنان، وخدمات الطوارئ الأولية وصيدلية للأدوية الأساسية.
كما يمكن تقديم خدمات الجراحات السريعة مع اعتماد نظام طبي مرن، ونظام اداري فعّال. ان توجهاً كهذا سيؤدي حكماً الى تحسن أكيد في مجال الخدمات خارج الاستشفاء وخفض تكلفتها بشكل ملحوظ.
2 ـ ويمكن للمؤسسات الضامنة ان تتعاقد مع مؤسسات رعائية موجودة (بدل ان تنشئ هي مراكز جديدة) مستوفية للشروط الفنية المفروضة ولشروط السلامة العامة (ان نطبق نظام اعتماد للمؤسسات الرعائية اسوة بنظام الاعتماد المطبق في المستشفيات). وان يتم الاتفاق على تعرفة للأعمال والخدمات المقدمة، وعلى نظام المراقبة وضمان الجودة.
3 ـ أن تعتمد الصناديق الضامنة موازنات مخصصة لتنفيذ برامج رعائية وهي على سبيل المثال لا الحصر:
برنامج التحصين الشامل للأطفال.
برنامج التثقيف الصحي.
برنامج الصحة المدرسية.
برنامج الصحة الانجابية.
برنامج الأدوية الأساسية للمؤسسات الرعائية التي تمتلك او تتعاقد معها.
برنامج أدوية الأمراض المزمنة للمستفيدين من تأميناتها.
برنامج الاكتشاف المبكر لبعض الأمراض السرطانية (خاصة سرطان الثدي، عند المرأة بعد 50 سنة، وسرطان البروستات عند الرجل، وبرامج الاكتشاف المبكر لبعض المشاكل الصحية مثل الكولسترول، والسكري.
ان هذا النوع من الانفاق يمكن تسميته الانفاق الايجابي لأن مردوده كبير جداً، فهو الى جانب توجهه لتحسين نوعية الحياة التي نعيش فهو اداة فاعلة جداً في التخفيف من معدل الحاجة للاستشفاء ومن معدل الحاجة للعلاج خارج الاستشفاء، وسيؤدي حكماً الى تأمين وفر كبير في انفاق هذه الصناديق.
4 ـ اعتماد الأدوية النظامية كأساس لقياس تكلفة الدواء في الفاتورة الاستشفائية.
ومن المفيد في رأينا اعادة تجربة الضمان في استيراد الدواء النظامي لتغطية حاجته وحاحة الصناديق الضامنة العامة الأخرى، أكان للاستشفاء أم للعلاج خارج الاستشفاء، خاصة بعد ان ألغت الدولة المكتب الوطني للدواء، على الرغم من كل ما كتب في حينه عن القدرة على خفض تكلفة الدواء بحدود 30 ـ 40%.
فالعودة الى الاستيردا من قبل الضمان لا بد منها اذا كانت الدولة صادقة في ما تقوله من توجه لخفض تكلفة الدواء، أو أن تعود لتبني مبدأ المكتب الوطني للأدوية ولتشرك القطاع الخاص برأسمال هذا المكتب (تجار الأدوية والصيادلة والأطباء والمواطنين) بمعدل لا يفوق 49% من رأسمال المكتب. ولقد سبق لنا وعايشنا التجربة الأولى للضمان الاجتماعي يوم استورد مباشرة الأدوية، واعتمدت خزائن خاصة لهذه الأدوية في الصيدليات مخصصة بالمضمون. وأذكر كيف ان دواء مثل Pentrexyl-500mg كان سعره 6 ليرات في خزانة الدواء للمضمونين، و12 ليرة خارج الخزانة لكل المواطنين، ويظهر ان التجربة توقفت لأنها كانت ناجحة.
ح ـ التأمينات الصحية والجسم الطبي
يلعب الطبيب دوراً أساسياً في السياسة الصحية الرعائية والاستشفائية. ومن هذا المنطلق من الطبيعي الافتراض بضرورة توفر علاقة مميزة وواضحة بين الطبيب والمؤسسات الضامنة والمريض والمستشفى. والمشكلة التي تحتاج الى معالجة هي كيف نوفق بين المؤسسة الضامنة والمريض والمستشفى والطبيب والمؤسسة الرعائية. المشكلة ان كل فريق على الرغم من صور التنسيق يعمل انطلاقاً من مصالحه، الأمر الذي انتج في مراحل سابقة علاقات مضطربة متوترة تارة بين الطبيب والمستشفى وتارة بينه وبين الصناديق الضامنة، وأخرى بين الصناديق والمستشفيات والكل مع المريض. ومن المعروف ان المؤسسات الضامنة لا تدافع عن مصالح المستفيدين من خدماتها، فتقوم المؤسسات الاستشفائية أو الأطباء باستفراد المرضى، وفرض مبالغ عليهم خارج القوانين والاتفاقات بحجج مختلفة، والمريض يدفع والصندوق لا يسأل ما دام هو لا يدفع من خزنته.
اذن كيف يمكن معالجة هذه المشاكل؟
المعالجة تنطلق من صلب مرتكزات نظامنا الصحي اي الحرية والمبادرة الفردية.
على المؤسسات الضامنة ان تعرض على الجسم الطبي التعاقد استناداً لتعرفة واضحة متفق عليها لمختلف أنواع الأعمال الطبية في العيادة، وفي المستشفى أو في منزل المريض.
ويتم التعاقد مع الأطباء الذين يقبلون شروط الضمان وهي شروط متفق عليها. ويتضمن العقد الفردي أم الجماعي مع الأطباء بنداً يفرض على الأطباء احترام الأصول الطبية والتعرفة، وكل مخالفة تدفع الصندوق الى مقاضاة الطبيب وفسخ العقد معه.
وعلى الأطباء أن يعلنوا وبشكل واضح في عياداتهم انتسابهم أم لا الى الصناديق الضامنة، مع تحديد واضح للتعرفة المعمول بها.
وعلى المؤسسة الضامنة أن تشجع الأطباء المتعاقدين معها، وذلك بتقديم تسهيلات لهم خاصة مقابل خدماتهم كأن يتم حسم نسبة من بدلات اشتراكهم السنوي في المؤسسة الضامنة.
وعلى المرضى أن يبلغوا إدارة الضمان بأي مخالفة معهم لتدخل المؤسسة الضامنة.
اما المرضى الذين يرغبون في الذهاب لأطباءغير متعاقدين مع الصناديق، فالعلاقة مع الطبيب متروكة للطبيب والمريض.
المرحلة الثالثة
البطاقة الصحية
انها تمثل مرحلة متقدمة من تنظيم التأمينات الصحية، البطاقة الاستشفائية اسست لدمج الضمان الاجتماعي بمرضى وزارة الصحة (غير المستفيدين من أي نظام تأمين عام) الى جانب توحيد المعايير والتعرفات والاتفاقات وأدوات الرقابة (المرحلة الأولى).
والبطاقة الصحية هي أداة لتنظيم الطلب على الصحة.
وتشمل خدماتها الاستشفاء ـ والخدمات خارج الاستشفاء وطب الاسنان وكافة الخدمات التي يقدمها الضمان الصحي.
التغطية الاجتماعية
تغطي البطاقة كافة شرائح المجتمع:
ـ المنتسبين للصناديق الضامنة العامة (ضمان ـ تعاونية ـ بلديات).
ـ مرضى وزارة الصحة (المرضى غير المستفيدين من أي ضمانات خاصة).
ـ عائلات العسكريين وذوي العهدة لديهم إذا اتفق على ذلك.
التغطية المالية
يتحمل الصندوق المركزي ما يلي:
ـ 90 في المئة من تكلفة خدمات الاستشفاء، و10 في المئة المريض، و80 في المئة من تكلفة الخدمات خارج الاستشفاء، و20 في المئة المريض.
وتوضع تفاصيل للتغطية المالية في حينه.
2 ـ توحيد الصناديق
عدة حلول ممكنة وهي للمناقشة:
أ ـ إلغاء الصناديق كافة وضمها الى الضمان الاجتماعي مع الحفاظ على المكتسبات الخاصة ببعض فئات الموظفين والضباط. حيث يتولى الضمان كافة المهام التي يمارسها حالياً، باستثناء أعمال الرقابة والتدقيق التي تمارسها شركة متخصصة.
2 ـ من الحلول التي تطرح إنشاء صندوق خاص (بنك موحد للتأمينات الصحية).
الخوف هنا من أن تعقد الأمور لذلك يجري الضمان العقود، أو تتولى مؤسسة خاصة التدقيق والمراقبة ويتولى البنك سداد المستحقات، مع إعطاء الضمان الاجتماعي الحق المطلق في مراقبة أعمال المؤسسة الخاصة بالتدقيق والمراقبة. كما ان البنك الموحد للتأمينات لا يدفع المستحقات إلا بعد تلقيه الموافقة النهائية من إدارة الضمان على نتائج التدقيق والمراقبة.
إن نظاماً كهذا مفيد كونه يوزع المهام بين مسؤوليات متناقضة ومكملة بعضها للبعض الآخر، انه نظام يعزز الرقابة والشفافية، وتبقى القابلية للتطبيق.
مصادر التمويل:
مصادر التمويل متعددة وهي: المؤسسات الخاصة، العمال في القطاع الخاص، والدولة التي تغطي حصتها من صندوق الضمان الاجتماعي، مع تغطية تكلفة ضمان موظفي الدولة والقوة العسكرية المعنية بالنظام.
وتدفع الحصة التي كانت توفرها لوزارة الصحة العامة لضمان استشفاء 40 في المئة من الشعب اللبناني غير المستفيدين أي تغطية خاصة أو عامة.
أما المواطن، اذا كان موظفاً في القطاع العام، فيدفع نسبة من راتبه وإذا كان غير مشمول بأي نظام تأمين فالبطاقة الصحية توفر له تغطية الخدمات الاستشفائية والخدمات خارج الاستشفاء.
وتقدر تكلفة الخدمات خارج الاستشفاء بنسبة 5 في المئة من خدمات الاستشفاء.
وعندها يعلن عن التأمين الاختياري للمواطنين غير المشمولين بأي نظام تأمين، ويحدد الرسم السنوي المفروض على المواطن وحصة الدولة مقابل ذلك. كما سبق وقلنا عند بحث المرحلة الثانية ان التأمين الاختياري يمكن ان يبدأ مع تنفيذ المرحلة الثانية، شرط ان تتوقف وزارة الصحة عن متابعة تقديم خدماتها للمواطنين وضم هذه المسؤولية للضمان الاجتماعي.
عندها فقط سنرى ان غالبية العائلات والمواطنين سيقدمون على التأمين الاختياري لمصلحتهم في ذلك خاصة وان الدولة ستستمر في تغطية القسم الأكبر من تكلفة الاستشفاء.
ان بلوغ سياسة تأمينات صحية فاعلة وقابلة للاستمرار والتطور منوط بالنجاحات الممكن تحقيقها في مجال تنظيم العرض انطلاقاً من الحاجة بواسطة الخريطة الصحية، كما في مجال تنظيم الطلب على الخدمة الصحية بواسطة البطاقة الصحية.



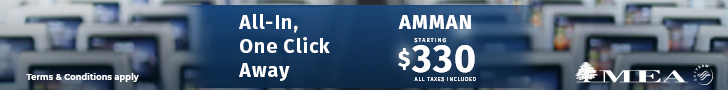

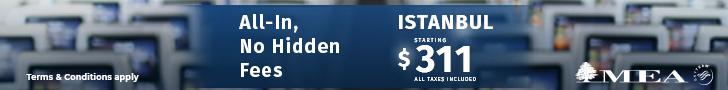
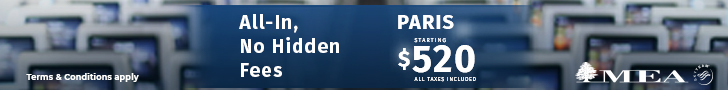



يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.