إتخذ إيهود أولمرت قراراً بالرحيل عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية. لم يجد مفراً من ذلك بعد توجيه اتهامات إليه في قضية رشوى. هل ستتمكن تسيبي ليفني، التي اختارها حزب كاديما لخلافته من تشكيل حكومة جديدة ولو بأكثرية ضيقة لا تتجاوز واحداً وستين نائباً من أصل مئة وعشرين يشكلون أعضاء الكنيست؟ ثمة احتمال يتمثل في بقاء أولمرت رئيساً لحكومة تصريف أعمال حتى آذار المقبل في حال عدم تمكن ليفني من تشكيل حكومة. وحتى لو شكلت حكومة، ستجد إسرائيل نفسها على أبواب انتخابات عامة في غضون سنة. سيتوجب على رئيسة الحكومة الإسرائيلية عندئذٍ مواجهة بنيامين نتنياهو زعيم تكتل ليكود... هذا في حال بقي حزب كاديما موحداً ولم ينفرط عقده.
من المفارقات أن الإسرائيليين يبحثون حالياً عن زعيم وقائد، فلا يجدون سوى فاشل إسمه بنيامين نتنياهو. ما يشير إلى فشل نتنياهو ماضيه القريب. لا يمكن تجاهل أنه لم يستطع أكمال ولايته بعدما خلف شمعون بيريس في رئاسة الوزارة في أيار/ مايو من العام 1996. وقتذاك، استطاع نتنياهو الوصول إلى رئاسة الوزراء بفضل العمليات الانتحارية التي نفذتها "حماس" وغير "حماس" في القدس وتل أبيب. كانت نتيجة تولي زعيم ليكود رئاسة الوزارة تحقيق هدف واحد هو استكمال القضاء على أي أمل في تحقيق تقدم على أي من مسارات العملية السلمية، خصوصاً المسار الفلسطيني. بمجيء نتنياهو إلى رئاسة الوزراء، انتصر ييغال عمير، قاتل أسحق رابين، على اتفاق أوسلو. وانتصرت مع القاتل جبهة عريضة تضم كل المتطرفين في المنطقة من إسرائيليين وعرب وغير عرب. سجّل نتنياهو خلال السنوات الثلاث التي تولى خلالها رئاسة الحكومة الفشل السياسي تلو الآخر. كان انتصاره الوحيد على عملية السلام التي لم تقم لها قيامة منذ تولي الرجل رئاسة الحكومة...
من الصعب التكهن بما إذا كانت ليفني ستنجح في تشكيل حكومة نظراً إلى التجاذبات السياسية التي تشهدها إسرائيل في هذه المرحلة بالذات. هذه التجاذبات تدور داخل حزب كاديما نفسه الذي صارت ليفني زعيمته، كما تدور بين ليفني وزعيم حزب العمل أيهود باراك. أكثر من ذلك، هناك أحزاب مثل "شاس" ستحاول ابتزاز ليفني ومنعها من تشكيل حكومة جديدة. في كل الأحوال، يبدو المشهد السياسي في المنطقة بائساً إلى حد كبير. صار الخيار بين نتنياهو وتسيبي ليفني التي تتولى وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ سنوات عدة، لكنها لم تظهر يوماً إنها تعرف ماذا تريد بأستثناء اطلاق كلام جميل عن رغبتها في السلام وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل. ما الذي فعلته ليفني من أجل تحقيق أي تقدم على صعيد العملية السلمية؟ لا شيء يذكر، أقله حتى الآن. لا شك أنها أفضل من نتنياهو، وهذا أسهل الأشياء، يكفي أنها أقل دموية منه. لكن الخوف الكبير ينبع من أنها تميل إلى كسب الوقت ليس ألا من أجل تكريس واقع جديد على الأرض يتمثل في إستكمال "الجدار الأمني" الذي يبتلع جزءاً من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
أنتهى زمن الزعماء الكبار القادرين على اتخاذ قرارات حاسمة في إسرائيل.
ما أنتهى عملياً هو الدور الأميركي الذي عرفناه في المنطقة. بالطبع، لا تزال الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم بغض النظر عما تعاني منه حالياً على غير صعيد، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، لكن الدور الذي لعبته في الماضي بين العرب والإسرائيليين يبدو وكأنه أنتهى، أقله لفترة ما. ما لا بد من التذكير به أن السلام بين مصر وإسرائيل لم يكن ممكناً لولا التدخل الأميركي المباشر الذي أوصل في العام 1978 إلى اتفاقي كامب ديفيد اللذين أفضيا إلى المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية في آذار من العام 1979. لولا التدخل الأميركي المباشر، لما انعقد مؤتمر مدريد الذي أدى لاحقاً إلى اتفاق أوسلو وإلى اتفاق السلام الأردني ـ الإسرائيلي وإلى مرحلة كانت فيها سوريا وإسرائيل على عتبة التوصل إلى اتفاق. الأهم من ذلك، أنه لولا الضغوط الأميركية المباشرة لما جاءت إسرائيل إلى مدريد على الرغم من أن رئيس الحكومة فيها كان وقتذاك أسحق شامير الرافض لفكرة السلام من أساسها.
لا حاجة إلى أستعادة التدخل الأميركي المباشر في كل شاردة وواردة في الشرق الأوسط، بما في ذلك التخلص من نتنياهو حين كان رئيساً للوزراء والذي كان الرئيس بيل كلينتون لا يطيق صورته. تبدو أميركا الحلقة المفقودة في العملية السلمية. يستطيع الرئيس بوش الأبن الحديث إلى آخر يوم من ولايته عن تحقيق نتائج بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك رؤية الدولة الفلسطينية وقد تحولت إلى حقيقة. لن يجد الرئيس الأميركي حتى من يتظاهر بأنه مستعد لتصديق كلامه. أنه وضع جديد في الشرق الأوسط يقود إلى التساؤل هل سيتغيّر شيء بعد مجيء إدارة جديدة، ما دام الأمل مقطوعاً من إسرائيل حيث صار الخيار بين ليفني ونتنياهو؟ إنه خيار بين أمرأة ضعيفة لا تعرف ماذا تريد... وبين سياسي بنى مجده على فكرة أنه دمر العملية السلمية في السنوات الثلاث التي كان فيها رئيساً للوزراء. إنه مشهد بائس بالفعل في الشرق الأوسط!


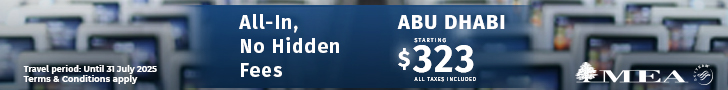
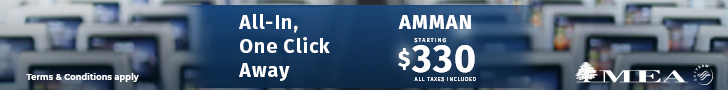

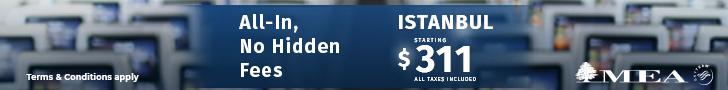
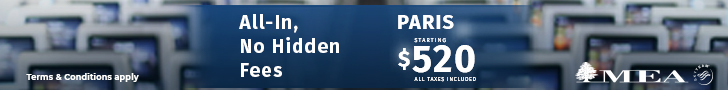



يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.